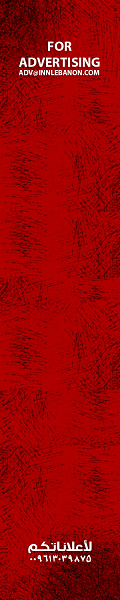صدرت عن منشورات المتوسط، رواية "مذكرات شرطي لبناني" لفوزي ذبيان. وفي هذه الرواية، يكتب فوزي ذبيان سيرته الذاتية الغنية والمتنوعة والشاقّة خلال عمله شرطيّاً في مؤسسة "قوى الأمن الداخلي" بلبنان. السيرة تبدو جانباً من المشهد اللبناني المتصدع المفكك الذي تأكله النوازع والمناكفات والميليشيات. تكشف الرواية عن عالم مجهول يبدو وكأنه سرّي، على الرغم من أن الجميع يعيش فيه، وعلى الرغم من علانيته، إلا أنه عالم مغطّى بطبقات كثيفة من رواية السلطة وإعلامها. وكان لـ"المدن" مع فوزي ذبيان هذا الحوار...- لماذا "مذكرات شرطي لبناني"؟ ألا تعتقد أن واقع أي شيء في لبنان يشبه واقع الشرطة؟كلا، لا نستطيع أن نقول أن لبنان دولة بوليسية إذا ما كنت تلمح إلى هذا الأمر. إما إذا كنت تقصد الواقع المؤسساتي في لبنان بشكل عام والمؤسسات الأمنية بشكل خاص، فالسؤال عندئذ بمحله. نعم، ثمّة اهتراء عصيب يعصف بكل مؤسسات هذا البلد والمؤسسات الأمنية أيضاً. فلا يجب أن يغيب عن البال أن لبنان العميق بعد الطائف أي لبنان الإدارات الرسمية هو لبنان الميليشيات. أما لماذا مذكرات شرطي لبناني، فلأن الموضوع يتعلق بي كشرطي سابق إلى أقصى الحدود. فأنا هو الشرطي في هذا العنوان وبصراحة القول تقصّدتُ المباشرة في العنوان بلا لف أو دوران. الكتاب هو تأريخ لنفسي بالدرجة الأولى، طبعاً كشرطي سابق، ثم هو تاريخ لنمط عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي كما عايشت هذا العمل بالفعل، واستطراداً باقي مؤسسات الدولة والتي تتشابك في يومياتها ومهامها مع مؤسسة قوى الأمن. وتراني محل فرح وغبطة عندما أسمع تلك التعليقات التي تشير إلى أن "مذكرات شرطي لبناني" هو بمثابة تاريخ آخر لبنان، تاريخ من تحت بين 1993 و2012 وهي الفترة التي كنت إبانها دركياً. لا أخفيك أني عانيت الأمرين أثناء هذه السنوات الطوال إنما مع كرّ الأيام الدركية وتواليها رأيت إليّ وقد انسجمتُ مع نفسي كدركي أو ولأكن أكثر دقة، رأيت إليّ وقد اقتنعت بهذا الكيان الذي تلبّسني وصرت ظاهرياً على الأقل منسجماً مع سيستم المؤسسة... انسجمت مع هذا السيستم وقد اكتشفت بالتدريج إمكانات مزاجية في شخصي كنت غافلاً عنها من قبل وهي إمكانات عززت فيّ بعض الميول التي تؤهلني لأن أصمد كل هذا الوقت كشرطي.- عدا عن مذكرات الشرطي، حتى في أعمالك السابقة تبدو مهجوساً بالعقل بالأمني أو الواقع الأمني، المراقبة في "أورويل في الضاحية الجنوبية"، "القبلة الابدية"، هل كان الانتساب الى الدرك أو الشرطة، نواة لمسار الكتابة؟ هل باتت الكتابة بالنسبة إليك، لغة اعتراض على الواقع الأمني، الرسمي الذي هو القوى الأمنية، والميليشيا ممثلة بحزب الله... وربما قوى أخرى؟بداية، لا يمكن على الإطلاق المماهاة بين القوى الأمنية الشرعية وحزب الله كقوة أمنية ضخمة فرضتها الظروف. فهذا الحزب ببداية الأمر ونهايته هو صدى متخثّر للخمينية في لبنان وبجوهر عقيدته لا تعنيه حدود الدول وجغرافيتها ودولة لبنان الكبير ضمناً. ففي مسعاه الأخير لإقامة دولة الإمام، كل الكيانات الجغرافية مؤقته وإن كان في سنواته الأخيرة يتكتم حيال هذا الأمر من باب التقية، وفي هذا السياق حزب الله هو وبال على الشيعة في لبنان أولاً ثم على أبناء الطوائف الأخرى من سنة ومسيحيين ودروز وأكراد وعلويين وملحدين وإلى آخره (بعد في حدا؟!!). أما المؤسسات الأمنية الشرعية فهي حتى في أقصى ضعفها تبقى لبنانية وتحمل لواء الدفاع عن هذا الوطن، أقله ببياناتها الرسمية. ولا يجب أن يغيب عن البال أن كل المؤسسات اللبنانية الرسمية هي بنهاية الأمر رهن السلوك السياسي للزُّمَر التي تحكم هذا البلد ما يعني أن ترهل هذه المؤسسات ودود الفساد الذي ينخر مفاصلها يوماً بيوم هو انعكاس لسوء الطبقة السياسية وما يحايث أذهان هذه الطبقة من دود وعفونة ميليشياوية. أما بالنسبة إلى الجزء الأول من السؤال: نعم، فأنا عايشتُ الحرب اللبنانية منذ بداياتها في السبعينيات مروراً بكل حروب الثمانينيات وصولاً إلى استيلاء زعماء ميليشيات هذه الحروب على الدولة ببداية التسعينيات، ما يعني أن ثمة مسكوتاً عنه أمنياً لطالما رسم حدود علاقتي بنفسي وبالآخرين وذلك على الرغم من الحس السلمي الذي يؤطر شخصيتي بشكل عام. أما في ما يتعلق بـ"أورويل في الضاحية الجنوبية" ثم "القُبلة الأبدية" وأنا أضيف "خيبة يوسف" فضلاً عن "قبلات السيّد" (عمل غير منشور)، فإن كل هذه الأعمال هي انعكاس لواقع حقيقي عايشته بنفسي وباللحم الحي، أي أن كلاً من هذه الأعمال تزخر بشخصيات حقيقية، بدءاً من حمودي والريس بنزاكسول وأبو زهرة في "أورويل في الضاحية..." ثم يوسف في "خيبة يوسف" وصولاً وبشكل خاص إلى حسين في "القُبلة الأبدية". فأنا تناولت الأرغيلة والقهوة والشاي مع هؤلاء في مقاهي الضاحية وغيرها، تناولت مع بعضهم الشاورما في هذا المطعم أو ذاك واستمعت ملياً لقصصهم وما تزخر به هذه القصص من خيالات وحقائق وأمنيات وخيبات أمل وصولاً ربما إلى انتحار أحدهم وأتوجه إليه بالأمنيات في أن يكون هانئاً حيث هو الآن. بالتالي، ربما تكون الخلفية الأمنية – بالمعنى الواسع للكلمة – قد انبثقتْ في كتاباتي باعتباري ربيب حروب هذا البلد وزعرانه من قادة محليين وعرب وأجانب، وربما هذا الأمر هو ما حفّز التحيّز إلى هذه الأنماط الروائية البسيطة بالظاهر والمعقدة بالعمق إلى حدّ كبير، لا سيما شخصية حسين في رواية "القبلة الأبدية". أما بالنسبة إلى السبب الذي يحدوني إلى الكتابة فأقول لك بكل بساطة أن الأمر يتعلق بتقطيع الوقت إلى أن أموت. أنا شخص ملول جداً واكتشفتُ عن طريق الصدفة أن الكتابة تسلّيني. فإذا ما نلت الإعتراف من الآخرين بأني كاتب ـ طبعاً بشروطي وبلا شطط اللياقات والتشبيك والضجة الميديائية – فسأكون في غاية الإمتنان والحبور. أما عن الخلفية الرسائلية أو الإصلاحية لفعل الكتابة فهذا الأمر لا يعنيني... لست أدري، ربما هو نورثروب فراي مَنْ قال مرة أن الروائيين هم جواسيس الله على الأرض وطبعاً هو كان يتكلم عن الإله الطيب، إلهٌ ما طيّب يريد الخير للبشر!! أما أنا فبعيد جداً من هذه المقاربة حيال مهمة الروائي في العالم ربما بسبب ما تمور به هذه البلاد من آلهة. بالنسبة إلي، وفي ما يتجاوز الآلهة الوثنية، كل الآلهة شريرة، وأنا أمقتها عن بكرة أبيها. جلّ ما أريده عبر فعل الكتابة هو أن أكون إله نفسي، نفسي فقط... أنا كائن ملول أريد أن أتسلّى.- لجأت إلى سكب الواقع كما هو على الورق بأحداثه المرة والمشينة بلغته وألفاظه النابية، ألا تعتقد أن الكتابة كانت تحتاج نوعاً من الايحاء والتلميح أو اعادة انتاج الحياة الموازية للواقع؟"مذكرات شرطي لبناني" هو كتاب عن الحياة الجوانية لرجال الشرطة في لبنان. ولدى قراءتي الكتاب بعد نشره اكتشفتُ أني مقصر جداً في إيفاء لغة الدرك حقها. فعلى الرغم من كثرة الألفاظ النابية، كما أطلقتَ عليها، والتي يحفل بها الكتاب، فأنا أرى العكس تماماً. لقد كنت بغاية التهذيب ومراعاة الخواطر في انتقائي للملفوظات التي تندرج في خانة السباب واللسان الزِّفر كما يسميه المأدبون من بعض المنافقين وغيرهم. بل ترى الكثير جداً من هذه الكلمات والعبارات كانت أقرب إلى الإيحاءات... إنما واستطراداً، أنا أستغرب بشدة أولئك الذين رأوا أن الكتاب يعجّ بالألفاظ الزعرة!! هل لك كمواطن لبناني أن تحصي كم مرة يكرر اللبناني باليوم الواحد العبارة التالية: "... إخت هل شغلة" أو "... بهل حياة" وما شاكل من عبارات؟!! أما بالنسبة إلى المؤدبين الذين يستنكرون هذا النمط من القول والذي أراه شعرياً إلى حد كبير، فأنا بالأصل لا أحبهم ولا يعنيني أن يقرأوا الكتاب أو لا يقرأوه... فأنا لا أستسيغ بالمرة تلك الأخلاق الرخوة التي تقوم على عيب غشيم وعلى نفاق اجتماعي وعلى سرديات في الثقافة ترتعب من كلمات الاعضاء الجنسية.- أيهما كان تحكّم في الآخر في الكتابة، الشرطي أم الكاتب؟ ذلك أن الروائي هنا قائم على مسارين في مسار واحد، عاشق الفلسفة الذي أصبح شرطياً، والشرطي الذي كتب مذكراته..على الرغم من معجم الشرطة الذي يزخر به "مذكرات شرطي لبناني"، أنا أصرّ أن فوزي الكاتب هو من خطّ نصّ فوزي الشرطي، وليس العكس، علماً أنه لا شيء يمنع تبادل الأدوار بين كل من الفوزيين. أنت تعلم أن بول أوستر في "ثلاثية نيويورك" لا يرى بأساً في أن يحل التحري مكان الكاتب، والعكس بالعكس، أما أنا وفي هذا السياق تحديداً، أرى أنه من الأجدى أن يكون الروائي عنصراً في مكتبة مكافحة الإرهاب مثلاً. فالإرهاب يلفنا من كل حدب وصوب سواء أكان إرهاباً مادياً أو معنوياً وربما هذا الأخير أخطر. لذا لا بأس في أن أكون عنصراً في مكتبة مكافحة الإرهاب إبان فعل الكتابة، فأكافح بالدرجة الأولى الملل الذي هو الإرهاب الأعظم في هذا العصر، ثم الإرهابات الأخرى التي لا يمكن أن تخطر في البال... جوابي النهائي على هذا السؤال – ولك أن تعتبرني كاذباً فأنا لن أزعل منك – هو أن فوزي الروائي هو من خط نصّ فوزي الشرطي... ولا بأس بنأمة من الشيزوفرانيا حيال هذا الوضع المكركب واللعين.- هناك نكتة عن أحد المستشارين المدنيين، أنهم أرسلوه الى العسكريين ليعلمهم أن يصبحوا مدنيين فأصبح عسكرياً؟ انت متى كنت تشعر أنك عسكري؟بالمعنى التداولي لكلمة عسكري في المجتمع اللبناني، ربما على كل منا أن يكون عسكرياً في هذا الموقف أو ذاك. إبان حياتي الدركية غالباً ما كانت تتلبّسني رغبة في أن لا أكون دركياً حتى وأنا في غمرة مهامي كدركي. لا أستطيع أن أضع حدوداً صارمة بين هوياتي المتعددة، وكوني شرطياً سابقاً، هي واحدة من هذه الهويات المتراكمة بلا انسجام ولا من يحزنون. غالباً ما يكون الشرطي فاشلاً في السياقات غير الشرطية وهو ما لمسته لمس اليد عندما شرعت بدراسة الفلسفة في الجامعة اللبنانية، ولمسته أكثر لما صرت أتردد على مقاهي شارع الحمرا، ولو لم يأخذ بيدي شخص اسمه موسى وهبة، لكنت اليوم فاليه باركينغ بأقصى الإحتمالات. كنت تراني وكأني في مهمة مراقبة، أكثر من كوني شخصاً قصد الكافيه للإسترخاء واحتساء القهوة... إنما مع نشر روايتي الأولى "إكميل" في العام 2005 تبيّن لي بوضوح أن كتابة الرواية تستلزم نمطاً من المراقبة والترصد والإنصات يتجاوز بكثير ذاك الذي يجب أن يتحلى به الشرطي. حسناً، يبدو أن ثمة تناصّاً بين الشرطي والروائي في شخصي ولا بأس بهذا الأمر، إنما ومنذ أن تقاعدتُ صرت أكثر أريحية مع الشرطي الذي كنته إذ صار ذلك الشرطي محل سيطرة مطلقة من قبلي على الرغم من أنه يفلت مني في هذا الموقف أو ذاك فتراني شرطياً من قمة رأسي إلى أخمص قدميّ. أما بالنسبة إلى ذلك المستشار الذي تحوّل إلى شرطي، فأنا لا أرى غرابة في الموضوع على الإطلاق، فبعض الموظفين المدنيين من الذين كانوا يشاركوننا كرجال شرطة هذا المركز أو ذاك بحكم وظيفتهم، كنت ألقاهم في بعض الأحيان أكثر شرطية منا... لست أدري، ربما كل منا يستبطن شرطيّه الخاص في هذا العالم الذي يحفل بكل أسباب الحاجة إلى المراقبة والترصد والتعقّب ووضع الإصبع على الزناد وصولاً إلى إطلاق النار.- ما رأيك بظاهرة الكاتب الذي يتحول شرطياً، بالمعنى المجازي؟إن الكاتب الذي يتحوّل إلى شرطي أخفّ وطأة بالنسبة إليّ من الكاتب الذي يتحوّل إلى سمسار علاقات عامة "وتشبيك" بغية الشهرة وهذه الحرتقات. فهذا ال "searching for recognition all the time"، إذا أردنا أن نستعير جوديث بتلر، يسيء للفنان أو الكاتب أو "البطيخ المحمّض". فبالنسبة إلى بتلر، شرط الحرية هو الشرط الأول لكل فعل إبداعي. أما رهن الكاتب نفسه لهذا النمط من السعي للشهرة وبْلا بْلا بْلا... ينزع عنه هذا الشرط، وبتلر محقة جداً في هذا الرأي. وبصراحة القول، هذا السعي والفعفطة من قبل هؤلاء يدفع بي في الكثير من الأحيان، وسحقاً للفايسبوك بهذه المناسبة، يدفع بي إلى القول: حبذا لو كان كل الكتّاب رجال شرطة بدلاً من كونهم كتّاباً... وبلا مؤاخذة من الجميع.- ما المشكلات التي واجهتك بعد نشر الكتاب؟لم أواجه أي مشكلة على الإطلاق إلا – نسبياً - مشكلة توقيع الكتاب. فأنا لا أحب التواقيع. إنما لدور النشر سياساتها في النشر والتوزيع ولا بأس بهذا الأمر إلى حد ما... بالنهاية لا شيء نكتبه لأنفسنا إلا لائحة المشتريات من السوبرماركت كما يقول العزيز آمبرتو إيكو... طيّب، إنه مشكل بسيط وتجاوزناه بسلام. لكن أتمنى على أي ناشر قد يقرأ هذا الحوار أن لا يطلب مني أن أقوم بحفلة توقيع في حال اتفقنا على كتاب ما... سأقبل إنما لن أكون مبسوطاً. إنما إتس أوكه... توقيع وبيقطع!!- هل مارست رقابة ذاتية؟بشكل عام عندما أمارس الحد الأدنى من الرقابة على نفسي أثناء الكتابة، أرى إليّ وقد تركت القلم وحيداً إذا أردنا أن نتصرف بمحمود درويش. (أنا أكتب بالقلم ثم أقوم بطباعة ما كتبته بعد ساعات أو أيام أو أسابيع). تسقط كل الكلمات مني وأتحوّل إلى كائن هش في نظر نفسي وذلك بصرف النظر عن دروب الرقابة في هذا السياق، سواء كانت رقابة على متن النص مراضاة للقارىء – وهذه أسوأ أنواع الرقابة – أو الرقابة على الذات خوفاً من التعرّض للأذية وهو أكثر ما عايشته أثناء كتابة "القُبلة الأبدية" التي تتكلم عن شبان شيعة من الضاحية الجنوبية أرسلهم حزب الله إلى الحرب في سوريا. أما مع "مذكرات شرطي لبناني"، صدقاً، كنت بمنتهى الأريحية ولم تسُقني أي عبارة دوّنتها إلى إعادة النظر فيها أو مداراة وقعها على الآخرين. كنت كمن يكتب لنفسه، كمن يفضفض بمعنى أدق. ليس من ضروب الوفاء مع الذات أن يراقب المرء نفسه أثناء تسجيله لذكرياته مهما كانت المدونة الناتجة عن هذه الذكريات صادمة... سحقاً، لماذا عليّ أن أداري الآخرين؟! أظن أني ككاتب لا أملك تلك الجينات التي تدفعني للوقوف على آراء الآخرين، وذلك في كل ما كتبته، فكيف الحال مع كتابي الأخير حيث، وبشكل من الأشكال كنت أقرأ ذاتي عبر هذه الكتابة.- هل أنت الجندي الطيب فوزي، تماثلاً مع الجندي الطيب شفايك؟هيدا أحلى سؤال... شُوْف: غالباً ما يقع الظن بأهلنا المساكين أننا سنتشبّث كل العمر بمسالك التربية التي أنشأونا عليها، بصرف النظر عما سيعتور حياتنا من ملمات وصعاب في هذه الحياة، الأهل من هذه الناحية هم أقرب إلى أن يكونوا محدودي الأفق إلى حدّ لا يطاق... مثلاً أنا التحقت بالدرك وكنت في سن الثامنة عشرة، ولو أني جاريت أهلي بما أنشأوني عليه، لكنت انتحرتُ من السنة الأولة في السلك. بالنسبة إليّ كقارىء منذ الصغر، وهو ما تعزز أكثر حينما كنت في الدرك، تراني محل ازدواجية في تلقي دروب التربية: أهلي من جهة، ثم الشخصيات الروائية التي أخذتْ تداخل حياتي من جهة أخرى. أحب أمي الراحلة كثيراً وكذلك أبي الميت، لكني لا أستطيع إلا أن أتجاوزهما عطفاً على قراءاتي. عندما قرأتُ "الطبل الصفيح" لغونتر غراس تحولتُ إلى أوسكار لفترة طويلة من حياتي، وهو ما حدث أيضاً لدى لقائي ستافروغين الشرير كما بثّه دوستويفسكي في "الشياطين"، أو كولفيلد "الحارس في حقل الشوفان" أو بوكوفسكي بالإجمال، وغيرهم الكثير الكثير، وصولاً إلى يوسف شفيك بطل الرواية الشهيرة لياروسلاف هاشيك. قرأتُ هذه الرواية أثناء خدمتي في وزارة الداخلةي وكنت مسؤولاً عن عناصر الحراسة بالإضافة إلى أمور أخرى، ولك أن تتخيّل أجواء الداخلية في بلد مثل لبنان، فرأيتُ إليّ أتماهى مع شفيك بما فاق توقعاتي البريئة. أكثر ما علّمني صديقي شفيك أن هذا العالم الذي نعيش فيه لا يرتكز على الحدّ الأدني من الصلابة... لا نقطة ارتكاز في أي من قراراتنا وإن كنا نتوقع العكس، أما كل الإستئناس والرواق والفرح الذي يطالعنا به العالم من آن إلى آن، إنما يحدث من طريق الصدفة. فحقيقة العالم تقوم على محض الفاجعة، فاجعة أبدية تراها تتجسّد في كل عصر عبر شكل من الأشكال. أنظر إلى هذا العالم الذي نعيش فيه الآن وإلى أولئك المعاتيه والمجانين والمجرمين الذين يديرون شؤونه... من الثنائي بايدن – ترامب إلى بوتين فخامنئي ثم رجل كوريا الشمالية وغيرهم الكثير، وصولاً إلى لبنان والمنطقة... أيّ عالم هو هذا؟! بالنسبة إلى واحد مثل الجندي يوسف شفيك، يشكل هؤلاء روح العالم بالمعنى الذي ذهب إليه هيغل مع بعض الشطط في التأويل ولا بأس بهذا الشطط على كل حال. إنه العالم بحقيقته وهو ما أرشدني إليه شفيك، بل تراه وقد أطّر علاقتي بهذا العالم بعيون الخفة واللامبالاة والسخرية وانتظار ما سيقع غداً، وهكذا دواليك. رسم شفيك حدود علاقتي مع العالم انطلاقاً من أمور بسيطة مثل تناول البوشار في السهرة وأنا محاط بقططي الجميلة، وعلى رأسهم صديقي الأعز في العالم، بلبل، القط الأسود الجميل. إنه عالم تريلالي، يمور بكل ما يغذي أسباب الفجيعة والنهايات. إنما وقد وعيت هذه الحقيقة بخفة شفيكية، فلماذا عليّ الخوف أو الإرتياب؟ فلأتفرّج وكفى، ولأحصي طيور الأبابيل تلك التي يسقطها متصارعو هذا العالم على بعضهم البعض، لا سيما في هذا البلاد الملعونة حيث جمهرة الأرباب... أما قصدي بطيور الأبابيل، فتلك المسيّرات التي تجوب أرجاء سمائنا، ذهاباً من عندنا، وإياباً إلينا... فلا يجب أن ننسى أن كتب اليهود المقدسة وكذلك كتب المسلمين تعج بهذه الطيور/المسيّرات... فلننتظر ماذا سيحصل، لننتظر فيل موتنا وكفى.- هل تحرّرت من سطوة المرحلة الأمنية بعد إصدار هذا الكتاب؟لست أدري. أحياناً أقول آمل ذلك، وأحياناً أقول: مش مهم.